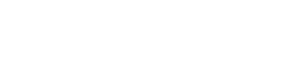الاستجابة لله وللرسول

عناصر الخطبة
1/ لا ينتفع بالقرآن إلا الصادق في طلب الهداية 2/ ما يدعو إليه الإسلام هو الحياة 3/ على العبد الاستجابة المطلقة لله ورسوله 4/ لا يذوق طعم الحياة الطيبة إلا صاحب القلب الحي 5/ نماذج من استجابة السلف لأمر الله ورسوله
اقتباس
وينبغي أن نعلم أن الحياة التي تحصل لنا من الاستجابة لما يدعونا إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعم من ذلك وأشمل من أن تكون الحياة الحسية، بل هي حياة حسية وحياة معنوية كذلك، بل لا تستحق الحياة الحسية اسم الحياة إلا إذا كانت حياة كريمة، إلا إذا صاحبتها الحياة المعنوية، وإلا فهي حياة بائسة غير مستحقة للأوصاف الكاملة للحياة ..
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها المسلمون: يقول الله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)، وإذا سمعت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فيجب أن تعطيها سمعك جيدًا، يجب أن ينفتح لها قلبك ويحضر تمامًا، أعطها كل انتباهك، أعطها كل حرصك، لا تسمعها بقلب غافل، أو كأنما الكلام لغيرك، فإن المصيبة تصبح عظيمة جدًّا إذا كنت تمر على قوله –تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا) فلا تتعظ، ويتلى عليك (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فلا تستمع، فمتى تستفيد بالقرآن؟! ومتى تستفيد بنداء الله؟!
إنه إذا ظل القرآن بيننا يتلى علينا ونحن على حال من الغفلة وعدم التدبر فلن نجني ثمرته، فإن القرآن لا يعطي كنوزه لكل أحد، ولا يمنح شفاءه لكل أحد، فإنه لا ينتفع به إلا الصادق في طلب الهداية، والمؤمن حاضر القلب الذي يتدبر القرآن بكل عقله وتفكيره، قال -تعالى-: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا) [الإسراء: 82]، ويقول -عز وجل-: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ) [ص: 29].
ولنعد -أيها المسلمون- إلى ذلك النداء الرباني الكريم ولنصغِ إليه بكل أسماعنا وأفئدتنا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) [الأنفال: 24]، ولنقف لنتدبر؛ إن الله -عز وجل- افتتح الآية بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)، فهو يخاطب قومًا مؤمنين موحدين، ثم يقول لهم: (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)، فنفهم من هذا أن المراد من الاستجابة ليس مجرد الدخول في الإسلام والنطق بالشهادتين، فإن هذا وأكثر منه قد وجد، وإلا لم يصفهم بالذين آمنوا، فالمراد إذن من الاستجابة لله وللرسول استجابة شاملة واسعة، استجابة للإسلام بكل ما فيه، استجابة لكل ما يدعو إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يدعو لأشياء تحيي الأمة وأشياء تميتها، معاذ الله أن يحدث ذلك، فالمعنى أن كل ما يدعوكم إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ففيه حياتكم.
فالمطلوب الاستجابة له في كل شيء دعانا إليه، استجيبوا إليه فيما دعاكم إليه من أذكار وصلوات، ومن أخلاق وآداب، بل ومن قتل وقتال، فحتى الحرب التي شرعها الله -عز وجل- والتي يظن البعض أنها هلاك للمسلمين لهي حياة المسلمين، ولذلك فسَّر عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قوله تعالى: (إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) فقال: أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذا يشبه تفسير أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة) [البقرة: 195]: أي بترك الجهاد فتصيبكم الذلة، ويهلككم عدوكم، فالمسلم لا ينظر إلى تحقق الحياة فيما يتعلق بنفسه، وإنما ينظر إلى تحقق الحياة لمجموع الأمة، وهذا هو منهج الإسلام، فهو دين جماعة لا دين أفراد، جماعة كالجسد الواحد، فلا بأس أن تُقتَل أنت وأُقتَل أنا ويُقتَل هو، وتحيا الأمة.
فهكذا تفهم كيف أن الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم -وإن كان أمرًا بحرب أو قتال- فيه حياة وإن قُتِلْتَ، وهكذا يجب أن يكون شعور المسلم وفكره، لا يفكر بصفته الفردية، فيريد حياة محدودة في شخصه وفي زمانه، وإنما ينتظر حياة للأمة، وإن أصابها ضر في وقت عابر، وإن قُتل وأُوذي منه بعض أفراد.
وهذا يقارب في المعنى قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ) [البقرة: 179]، فقد يعجب الإنسان لأول وهلة كيف يكون القصاص بقتل الشخص حياة؟! ثم مع التدبر تفهم على الفور أن القضية سهلة واضحة؛ فإنه إذا قُتل الجاني الواحد كفَّ ألوف الجناة عن ألوف من عمليات القتل، فقُتل واحد وحَيَتْ ألوف، فهكذا يكون في القصاص حياة، ويكون في القتال حياة، حياة للأمة والمجموع، بل قد يكون في الجهاد مع الإقدام والشجاعة حياة حسية للفرد كذلك، كما قال خالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة، فلا نامت أعين الجبناء ولا قرت نفوسهم. هذا مع العلم أن المسلم لو قتل فقد نال حياة كريمة بالفعل؛ إذ يقول -عز وجل-: (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ) [آل عمران: 169 ـ 172].
تأملوا -أيها المسلمون- وتدبروا آيات الله، فبعد أن ذكر الله -عز وجل- ما في الجهاد والقتل في سبيل الله من حياة، أتبع ذلك بالثناء على من استجاب لله والرسول في ذلك الجهاد الذي فيه تلك الحياة، ومن هنا تفهم أن ربط عروة بن الزبير -رضي الله عنه- الاستجابة للحرب بالحياة في تفسير قوله تعالى: (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)، كان ربطًا دقيقًا موافقًا للقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضًا.
هذا، وينبغي أن نعلم أن الحياة التي تحصل لنا من الاستجابة لما يدعونا إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعم من ذلك وأشمل من أن تكون الحياة الحسية، بل هي حياة حسية وحياة معنوية كذلك، بل لا تستحق الحياة الحسية اسم الحياة إلا إذا كانت حياة كريمة، إلا إذا صاحبتها الحياة المعنوية، وإلا فهي حياة بائسة غير مستحقة للأوصاف الكاملة للحياة.
ولذلك قال -عز وجل-: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) [النحل:97]، أي في الدنيا، (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 97] أي في الآخرة. فقال -عز وجل-: (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)، للتنبيه إلى أن الحياة بغير الإيمان والعمل الصالح حياة غير طيبة وغير محمودة، فليس للقلب لذة ولا سعادة ولا تصحيح إلا بحصول ما
يصلحه من الصلة بالله والطاعة، وتلك الحياة المعنوية حاصلة حتمًا لكل مؤمن استجاب لله وللرسول، ولو عُذب أو قُتل، فلم يذق طعمَ الحياة صاحبُ القلب الميت، وإن كان في الدنيا في كل نعيم مادي، ويتذوق طعمَ الحياة الكريمة صاحبُ القلب الحي الموصول بالله، المتحرر من الذل والخضوع لغير الله، وإن أوذي وطورد.
فإلى الجبناء الذين يخافون على حياتهم ظنًّا منهم بأن تمسكهم بالإسلام يهدد حياتهم، وإلى الذين لا يفقهون معنى الحياة ومعنى الكرامة، نقول لهم: حياتكم التي تخافون عليها في التزامكم بالإسلام، وحملكم لرسالة الإسلام، وتطبيقكم لمنهج الإسلام، فليس في الإسلام شيء إلا وهو سبب للحياة الكريمة الرفيعة بحمد الله، وكل ما يدعونا إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو حياة، فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الحياة بكل صور الحياة، وبكل معاني الحياة.
فإنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول، وتطلقها من قيود الجهل والخرافة، ومن ضغوط الأوهام والأساطير، ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة أو ما يسمونه بالحتميات القاهرة، ومن ذل العبودية لغير الله، للعبيد أو للشهوات.
ويدعوهم -عليه الصلاة والسلام- إلى شريعة من عند الله، تعلن تحرر الإنسان وتكريمه، بصدورها عن الله وحده، ووقوف البشر كلهم صفًّا متساوين في مواجهتها، لا يتحكم فرد في شعب، ولا طبقة في أمة، ولا جنس في جنس، ولا قوم في قوم، ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارًا متساويين، في ظل شريعة صاحبها الله رب العالمين.
فيدعوهم -عليه الصلاة والسلام- إلى منهج كامل للحياة والتفكير والتصور، يتمشى مع الفطرة التي أوجدها بارئها وخالقها العليم بها.
ويدعوهم -عليه الصلاة والسلام- إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم، والثقة بدينهم وربهم، والانطلاق في الأرض كلها لتحرير الإنسان بجملته، وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده، وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله، فاستلبها منه الطغاة.
ويدعوهم -عليه الصلاة والسلام- إلى الجهاد في سبيل الله؛ لتقرير ألوهية الله سبحانه في الأرض وفي حياة الناس، وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة، ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه وحاكميته وسلطانه، حتى يفيئوا إلى حاكمية الله وحده، وعندئذ يكون الدين كله لله، حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة، وللأمة من ورائهم حياة، فذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهي دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة، في كل صورها وأشكالها، وفي كل مجالاتها ودلالاتها.
والتعبير القرآن يجمل هذا كله في كلمات قليلة موحية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) [الأنفال: 24]، فهل أنتم مستجيبون لله ولرسوله؟! هل أنتم مستجيبون لهذه الحياة؟! وهل تعلمون كيف كانت الاستجابة لأصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهذه الحياة؟! وكيف صارت استجابتنا؟! هذا ما سنشير إلى طرف منه بعد قليل إن شاء الله.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن التاريخ يشهد بالاستجابة الرفيعة النادرة التي تميز بها الصحابة الكرام، وإن صور تلك الاستجابة واستقصاءها أمر يستحيل إدراكه والطمع في تحقيقه في هذا المقام، فهو بحاجة إلى مجلدات وأسفار، فكل حياة الصحابة صور لهذه الاستجابة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، والذي نريد أن نقوله: إنها كانت استجابة كاملة في جميع أمورهم، ما دقَّ منها وخفي، وما عظم منها وظهر.. استجابوا له في مشاعرهم وخواطرهم، استجابوا له في خاصة أمورهم وفي ملابسهم ومساكنهم ومطاعمهم ومشاربهم. ومن ذلك تلك الاستجابة الرفيعة لقوله تعالى: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:91] في تحريم الخمر، فإنهم بمجرد سماعها إذا بالمدينة المنورة تسيل طرقها بالخمر، والذي كان الكأس على فمه لم يكمل شربته وألقاه عنه.
ومن قبل ذلك وحين دعاهم -عليه الصلاة والسلام- إلى الهجرة، استجابوا له على الفور في تضحية فريدة، فهانت عليهم أموالهم، وهانت عليهم نفوسهم، وهانت عليهم عشيرتهم وأرضهم، وانطلقوا إلى نداء الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتركوا ديارهم وأموالهم، وغادروا أوطانهم، ونسوا لذاتهم، وهجروا راحتهم، وبذلوا مهجهم؛ إعزازًا لدين الله، وإعلاءً لكلمته، ونصرة لشريعته.
ولما دعاهم -عليه الصلاة والسلام- بعد غزوة أحد في اليوم التالي على الفور إلى الخروج مرة أخرى في غزوة حمراء الأسد، استجابوا له استجابة المؤمنين الصادقين، فخرجوا للغزو ودماؤهم لم تجف بعد، وجراحهم لم تبرد، وهم ناجون بشق الأنفس من الموت في معركة أمس، وهم لم ينسوا بعدُ هولها ومرارتها وشدة كربها وهمها، وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا، ولكنها إرادة الله؛ حتى يشعر المسلمون، وحتى تشعر الدنيا كلها بتلك الحقيقة العظيمة؛ حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء إلى نفوس أصحابها، ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها، وليس لهم من غاية في حياتهم سواها، عقيدة يعيشون لها وحدها، فلا يستبقون شيئًا من أنفسهم لا يبذلونه لها، خرجوا -رضوان الله عليهم- في استجابة سريعة، سعداء بتقديم أنفسهم لله، وبتلبية أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا أحدهم يقول: شهدنا أحدًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وأخي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي -أو قال لي-: أتفوتنا غزوة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت أيسر جراحًا منه، فكان إذا غلب حملته.
وفي ذلك جاء ثناء الله -عز وجل- عليهم: (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ)، أي من بعد ما نزل بهم الضر وأثخنتهم الجروح، (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) [آل عمران: 172-174]. وكانوا -رضوان الله عليهم- يبكون ويحزنون إذا أصابهم عذر قاهر شرعي يمنعهم من المشاركة مع غيرهم في أمر فيه استجابة للرسول -صلى الله عليه وسلم-.
استمع إلى قول الله تعالى: (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: 92]. فانظروا واعجبوا كيف لا يفرحون بما مُنِحوه من عفو بسبب عذرهم القهري الذي لا دخل لهم فيه، بل يحزنون أنهم لا يستطيعون شراء راحلة يخرجون عليها للقتال في غزوة تبوك التي تبعد المسافات الشاسعة، فعزّ عليهم أن يروا إخوانهم المسلمين خارجين للجهاد مقدمين أنفسهم لله، وهم متخلفون، عزّ عليهم أن تراق دماء إخوانهم في ساحات الوغى وهم في منازلهم وأهلهم هانئون، رغم أنهم معفو عنهم معذورون؛ وذلك لصدق إيمانهم، ورغبتهم الصادقة في نصرة الله، والاستجابة لرسوله -صلى الله عليه وسلم-، فأي استجابة عرفها التاريخ مثل تلك الاستجابة التي تفرد بها صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟!
فإذا ما غيرنا وجهتنا وحولنا أبصارنا للنظر في واقعنا -نحن المدللين المترفين- فإننا نخفي وجوهنا، ونسترها بأيدينا، ونتوارى أسفًا وخجلاً ونحن نقلب صفحات حياتنا بحثًا عن صور الاستجابة لله وللرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإذا بنا نجد أمورًا مؤسفة، نجد إيثارًا للدنيا واستحبابًا لها وتثاقلاً إليها، نجد أعذارًا تافهة، وحججًا واهية، يحتج بها المفرطون على تفريطهم، وهي حجج كلها تدل على نفسٍ خلاصةُ الأمر فيها أنها لا تريد أن تضحي أو تتعب أو تتحمل في سبيل الله.. نفس بخيلة على دين الله، نجد نكوصًا عن الاستجابة لأوامر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتثبيطًا من غير المستجيبين للمستجيبين، أو تعويقًا وإيذاءً لهم.
ومن الصور التافهة ما عرفه الجمع مؤخرًا من المواقف السيئة التي وقفها بعض مديري المدارس بعد بدء الدراسة من بعض الطلبة الذين استجابوا لأمره -صلى الله عليه وسلم- وأعفوا لحاهم، ونحن نعلم أن إعفاء اللحية أمر من الدين وليس الدين كله، فلسنا -بحمد الله- من الحمقى أو المغفلين، ولكننا لسنا من المتميعين، أليس إعفاء اللحية من الدين؟! أليس مما دعانا إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟! الجواب: بلى. إذن فلم لا نستجيب؟! هذه هي القضية: فنقول وقف أولئك المديرون الذين لم يستجيبوا لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الطلبة المستجيبين لأمره -صلى الله عليه وسلم- موقفًا تافهًا سيئًا، زاعمين أنهم سيمنعونهم من الانتظام في الدراسة ما داموا مستجيبين لأمره -صلى الله عليه وسلم- بإعفاء لحاهم، وتعرضوا لهم بصور مختلفة، فمنهم من تعرضوا لهم بالرفد، ومنهم من تعرضوا لهم بالسب والتهديد والاستهزاء، ومنهم من تعرضوا لهم بتأليب آبائهم وأقربائهم عليهم، وتخويفهم وإلقاء الرعب في قلوبهم، وغير ذلك من الأساليب الدنيئة، محتجين على أفعالهم القبيحة بمقالة تافهة ساقطة قائلين: (القانون يمنع دخولكم المدرسة ملتحين)، ونقول لصاحب هذه المقالة: إن كنت كاذبًا -وهذا هو الغالب؛ لأن الأمر ليس عامًَّا في جميع المدارس، فبعض المدارس بها الملتحون لا يتعرض لهم أحد- فقد جمعت بين عدة مصائب: الجبن والكذب ومحادة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومحاربة سنته، وإن كنت صادقًا فليس ذلك بعذر لك، فاستحباب المنصب والجاه جريمة وليس بعذر؛ قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ) [النحل: 107]، فحب المنصب والدنيا ليس بعذر. قف وقفة لدين الله ولنصرة أتباع المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، افعل شيئًا تدخل به الجنة، قدِّمْ شرع الله على قانون البشر، ماذا سيصيبك؟! ماذا سيحدث لك؟! فإن لم تستطع فاترك مكانك، فلأن تأخذ حبلاً فتحتطب وتسترزق الله؛ خير لك من أن تأتي الله بمنصب حقير يحمل معه وزر محادة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومشاقته؛ إذ كيف يأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمر وتأمر بخلافه، من أنت أيها الطاغوت الصغير الذليل؟! ألم تسمع قول الحق -تبارك وتعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ) [المجادلة:20]، (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [النساء:115]؟!
فمثل هذا الطاغوت الصغير ينبغي أن يزجر ويؤدب، وعلى كل من استجاب لأمره -صلى الله عليه وسلم- أن يثبت ولا يعبأ بأمثال هؤلاء الذين ضعفوا عن الالتزام بأمره -صلى الله عليه وسلم- ثم لم يتركوا غيرهم ممن أعانهم الله على اتباعه -صلى الله عليه وسلم-، ولابد أن يلاقي الإنسان بعض المتاعب في سبيل الله، وإلا فبم تدخلون الجنة؟! (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [البقرة: 214]، فاحذروا أن تكونوا من تلك الأصناف الضعيفة الخاسرة التي ذمها الله في كتابه بقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ) [العنكبوت: 10]، وقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) [الحج: 11].
استجيبوا جميعًا -أيها المسلمون- لنداء ربكم وجميع أوامر رسولكم، قبل أن تتمنوا ذلك فلا تجابوا، يوم لا ينفعكم شيء تقدمونه إذا ما فاتتكم هذه الاستجابة، قال تعالى: (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ) [الرعد: 18].
اللهم ارزقنا إيمانًا ليس بعده كفر، إيمانًا ثابتًا في الشدة والرخاء، لا يضطرب ولا يتزعزع، اللهم أحينا على الإسلام، وتوفنا على الإيمان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.